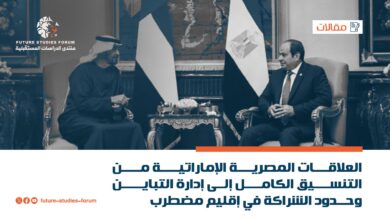قد تبدو الإجابة عن السؤال المطروح أمرًا سهلًا بالنسبة لكثير من القراء والمتابعين، غير أن تقديم إجابة موضوعية عنه تحتاج إلى: النظر في الشواهد التي تدل على تدهور في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وتلك التي تثبت أننا أمام واقع لم يتغير عن أوضاع ما قبل “طوفان الأقصى”، ومقارنة الأقوال التي تصدر عن البلدين، بالأفعال التي تترجمها التعاملات الأمنية والاقتصادية والتجارية بينهما.
وما يزيد الأمر تعقيدًا أن الإجابة تتطلب تنحية الانحيازات السياسية والفكرية والأيديولوجية جانبًا، وهذه مسألة لا تقل صعوبة بأي حال من الأحوال، مع حالة الاستقطاب المستمرة في مصر.
تنقل لنا التصريحات المتبادلة وبعض المواقف صورة علاقات متوترة تتحدث عنها الصحافة المحلية في البلدين والعالمية، وتفرد لها مساحات واسعة، وتقدم عليها أدلة وبراهين. فعلى سبيل المثال، يَعتبر الإسرائيليون عدم تعيين سفير مصري في تل أبيب، رغم مرور أكثر من عام على انتهاء عمل السفير المصري الأخير لدى الكيان الصهيوني، خالد عزمي، وكذا تأخر القاهرة حتى الآن في قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي، أوري روتمان، الذي اختارته دولة الاحتلال مطلع عام 2024م وأطلعت مصر على تعيينه سفيرًا لها في مصر، بعدها بثلاثة أشهر (في أبريل من العام نفسه)، بعد نهاية عمل السفيرة السابقة أميرة أورون، يعتبرون ذلك دليلًا على توتر العلاقات بين البلدين، بينما ينظر دبلوماسيون مصريون إلى أن مصر اختارت أن تعبر بشكل جزئي عن غضبها من إسرائيل عبر هذه الخطوة.
ثمَّة علامة أخرى على هذا التوتر ترتبط بما نُشِر عن خفض مصر مستوى التنسيق الأمني مع إسرائيل إلى الحد الأدنى حتى إشعار آخر، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة. غير أن هذه الخطوة ورغم تأييدها من زعيم الأغلبية في البرلمان المصري، فإن ما نُشِر حولها في مواقع وصحف مصرية وكذا عبرية، تبدو جميعها منسوبة إلى قناة العربية ومصادر سعودية، من دون تأكيد من مصدر رسمي مصري، أو حتى إسرائيلي. وهي خطوة، إن صَحَّت، يمكن النظر إليها على أنها دليل أكبر على التوتر القائم في العلاقات بين البلدين.
يشار كذلك إلى أن أحد الأسباب المعلنة حول التوتر يتعلق بموقف مصر الرافض لتهجير سكان القطاع، وهو موقف متماسك منذ بداية الحرب، ويأتي على عكس الرغبة الإسرائيلية، وبينما تصر مصر طوال الوقت على رفض سيناريو التهجير واعتباره خطًّا أحمر يضر بأمنها القومي، اعتبر نتنياهو مصر مسؤولة عن الكارثة الإنسانية في غزة لأنها لا تسمح بمرور المواطنين الفلسطينيّين إلى مصر عبر معبر رفح وأنها تقوم “بسجن سكان غزة رغمًا عنهم، وهم يرغبون في مغادرة مناطق القتال”، وهو تصريح كان الهدف منه إحراج مصر وفرض سيناريو التهجير عليها.
يضاف إلى ما سبق، التصعيد اللفظي المتبادل حول انتهاك اتفاق السلام؛ وخصوصًا من الجانب الإسرائيلي؛ فرغم ما قامت به إسرائيل من انتهاك للاتفاقية باحتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، ومعبر رفح، فإنها تمارس ضغوطًا بدأت في البداية على المستوى الإعلامي؛ ومصادر أمنية غير معلنة، زعمت أن الوجود العسكري المصري في سيناء وصل إلى نقطة تمثل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي الإسرائيلي، وأن المصريين يبنون قواعد عسكرية، بعضها ذات طابع هجومي، تشمل توسيع مدارج مطارات لاستيعاب طائرات مقاتلة، وإنشاء مخازن صواريخ تحت الأرض، في مناطق تنص معاهدة السلام على أن يكتفى فيها بالأسلحة الخفيفة. ووصلت هذه الضغوط في النهاية إلى رئيس الحكومة نفسه الذي طالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على مصر لخفض وجودها العسكري في سيناء، واستغل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل (15 سبتمبر الماضي) ليقدم له قائمة بالأنشطة التي تمارسها مصر في سيناء، واعتبارها انتهاكًا لاتفاقية كامب دافيد 1979م. وعلى الرغم من رفض مصر الاتهامات الإسرائيلية، فإن الإعلام العبري لم يتوقف عن ترويج هذه المزاعم، إضافة إلى تركيزه على عبارات بعينها في خطاب السيسي في قمة الدوحة الأخيرة يدعو فيها الحكومات العربية والإسلامية للتكاتف في مواجهة “العدو”، في رسالة موجهة إلى إسرائيل.
لكن في مقابل هذه التصريحات والمواقف التي تظهر التوتر حقيقيًّا، هناك مواقف تكشف أننا أمام سيناريو توتر وغضب مفتعلين، وأن العلاقات تسير كما هي، بل وربما أفضل في بعض المجالات.
التعامل الاقتصادي والسياسي
ويمثل التعامل التجاري والاقتصادي مع الاحتلال أكبر دليل على استمرار العلاقات المصرية الإسرائيلية في إطارها الطبيعي؛ فخلال الشهور الماضية، وفي أخطر لحظات القصف الإسرائيلي وحرب الإبادة وقعت مصر مع إسرائيل عقدًا لاستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي مقابل 35 مليار دولار، في خطوة لا يمكن النظر إليها إلا أنها تدعم الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه مشاكل جمة نتيجة تكاليف الحرب. ما يُعمِّق هذه النظرة أن مصر كان أمامها بدائل متعددة لاستيراد الغاز الطبيعي، لكنها اختارت استيراد الغاز الذي سطت عليه إسرائيل في شرق المتوسط قبالة سواحل لبنان وغزة، بل ومصر نفسها.
ولا يقتصر التعامل التجاري مع إسرائيل على هذا الأمر، بل يمتد لمواد أخرى تسهم في التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة؛ فقد شهدت صادرات الإسمنت المصري للكيان الصهيوني طفرة تاريخية؛ حيث قفزت وفقًا للبيانات الرسمية في البلدين من نحو 53 ألف طن في 2022م، إلى 2.4 مليون طن في 2024م، وهي زيادة تتجاوز الرقم السابق بـ 45 مرة، انتقلت فيها إسرائيل من المركز 35 في قائمة صادرات الإسمنت المصري عام 2022م، إلى المراكز الرابع في ظِل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وهذه الزيادة كشفت عن مفارقة أخرى؛ حيث تراجعت أسعار الإسمنت الذي يشتريه المستوطن الإسرائيلي، مقابل ارتفاع كبير في أسعاره على المواطن في مصر.
ويمتد التبادل التجاري بين البلدين ليشمل تصدير منتجات مصرية كيميائية وآلات ومعدات، ومنسوجات، وفواكه وخضروات، ومشروبات… وهنا يطرح السؤال المنطقي: كيف يمكن أن تكون العلاقات متوترة بين البلدين بالشكل المقصود إيصاله للشعوب، بينما تشهد العلاقات التجارية هذا النمو غير المسبوق؟
إذا انتقلنا من الاقتصاد إلى عالم السياسة؛ نجد أن النظام المصري اتخذ موقفًا حاسمًا بعدم فتح معبر رفح أمام حركة البضائع إلى قطاع غزة، وهو ما فاقم من الأزمة الإنسانية في غزة رغم القوانين الدولية التي ترفض الامتثال إلى أي ممارسات من شأنها مفاقمة الأزمات الإنسانية، وهو ما عُدَّ من قبل كثيرين مشاركة مصرية في الحصار، خصوصًا أن السلوك المصري بدا وكأنه يرفع الحرج عن الكيان الصهيوني الذي يغلق المعبر من جهة قطاع غزة.
ما يدعم ذلك أن النظام المصري حرص على منع الوفود الأجنبية المتضامنة مع غزة وسكانها من العبور إلى الجانب الفلسطيني من المعبر بحجة أن إسرائيل هي مَن يغلقه وأن البروتوكولات تمنع فتحه من دون تنسيق أمني.
يضاف إلى ذلك كله منع النظام أي مظاهر دعم شعبي للمقاومة، أو رافضة للعدوان الصهيوني، بل وإلقاء القبض في مناسبات عدة على نشطاء قرروا التحرك الشعبي ضد الإبادة، وآخرها اعتقال بعض الراغبين في المشاركة في أسطول الحرية. يضاف إلى ذلك كله أن الإعلام المصري، الموجه من أجهزة الدولة، تعمَّد استخدام لغة تحريضية ضد المقاومة الفلسطينية ورموزها، واستخدم خطابًا عدائيًّا ضدها في أكثر من مناسبة.
التوتر بين الحقيقة والافتعال
هكذا إذا تبدو الصورة متداخلة ومحيرة في الوقت نفسه، وقد يصبح من الصعب أمام هذه البيانات المتضاربة الحكم حول حقيقة التوتر أو افتعاله. غير أننا حين نقارن مؤشرات حقيقة التوتر بمؤشرات افتعاله يمكن أن نقول إن الإجراءات التي اتخذها النظام المصري في مواجهة غطرسة إسرائيل وقصفها عواصم عربية وإسلامية في سياق حديث مسؤوليها المتصاعد عن إسرائيل الكبرى، وحرب الإبادة التي تنفذها في غزة، وحتى انتهاكها اتفاقية السلام باحتلال محور صلاح الدين هي أقرب للرمزية، بينما على الجانب الآخر تبدو مؤشرات الافتعال فعلًا حقيقيًّا، لا مجرد خطوات رمزية.
يضاف إلى ذلك أن ما يجري الآن لا يمكن أن ينفصل عن تجارب النظام السابقة مع الكيان الصهيوني، في هذا الظرف، وطوال عامين، أو حتى في ظروف سابقة. وهي تجارب تثبت مدى اهتمام المستوى الرسمي في مصر، وليس الشعبي بالطبع، بتقوية العلاقة مع إسرائيل، والحرص على التنسيق الأمني. والأكثر من ذلك أن بعض الخطوات التي قامت بها مصر في سيناء هي أقرب لتحقيق مصالح الأمن القومي الإسرائيلي عنه من المصري؛ ولا أدل على ذلك من إخلاء مدينة رفح المصرية، وإجلاء سكانها لإنشاء مناطق عازلة تمتد عدة كيلومترات من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، علاوة على سعي مصر الدؤوب لهدم الأنفاق بين سيناء والقطاع، وكانت تمثل مصدر حياة وإمداد للمقاومة الفلسطينية.
وعلاوة على ما سبق فإن رد فعل مصر، ودول عربية وإسلامية أخرى، على الخطة الأخيرة التي أعلن عنها دونالد ترامب “لتحقيق السلام ووقف الحرب”، والتي تلبي لإسرائيل أهدافًا لم تستطع تحقيقها رغم الإبادة الممتدة لعامين، كان موقفًا متسقًا مع تلك التجارب القديمة؛ فقد جاء بيان مشترك وقعته مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر يرحب “بالدور القيادي للرئيس الأمريكي وجهوده الصادقة لإنهاء الحرب.. والاستعداد للتعاون بشكل إيجابي وبنَّاء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإنجاح الاتفاق وضمان تنفيذه”.
والحقيقة أن البيان المُعلَن على هذا النحو هو داعم لإسرائيل في المقام الأول؛ إذ أنه يضع مزيدًا من الضغوط على حركات المقاومة، وفي مقدمتها حركة حماس، ويخفف في المقابل كثيرًا من الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو في الداخل المحتل، وفي الخارج بدرجة أكبر، لأن أي رفض من المقاومة للخطة سوف يوظف إعلاميًّا ضدها على المستوى الشعبي العالمي، وهو ما بدأ نتنياهو توظيفه فعليًّا عقب لقائه ترامب بقوله “بدلًا من أن تعزلنا حماس، قلبنا الأمور عليها، وقمنا بعزلها… العالم أجمع، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي يضغط على حماس لقبول الشروط التي وضعناها مع الرئيس ترامب”. وهذا يعني أن الموقف العربي قد يسهم بقوة في تخفيف الضغط عن إسرائيل، بل وقد يؤدي كذلك إلى رفع العبء عن كاهل بعض الحكومات الغربية التي ترفض شعوبها الإبادة الإسرائيلية، وما حدث في إيطاليا خير دليل على ذلك. لقد بات من المفهوم أن المزاج الشعبي العربي أصبح مدركًا أن النظام العربي يريد التخلُّص من الصداع الذي سببته المقاومة، لكن غير المفهوم هو أن تحركات هذه الأنظمة، ومنها مصر بالطبع، من شأنها أن تسهم في تخفيف الضغط الشعبي العالمي ضد الكيان الصهيوني، الذي بانت آثاره في حفلات الموسيقى، والغناء والأنشطة الرياضية، فضلًا عن الملاحقات الجنائية للقادة والعسكريّين الإسرائيليّين، والتضييق العالمي على السيَّاح الإسرائيليّين.
وهكذا تبدو الرؤية أكثر وضوحًا، فبينما ترجح الأقوال حالة توتر حقيقية، فإن الأفعال تضعنا أمام سيناريو أقرب أن يكون مصطنعًا. وهذا لا ينفي بالطبع ما تقوم به إسرائيل من مراقبة أي تحركات مصرية سياسية أو عسكرية، والتحسُّب المستقبلي لها، والتجهُّز لأي عمل عسكري تعلم أنه سيقع يومًا ما، لكن الجانب المصري، على المستوى السياسي على الأقل، لا يتعامل مع الكيان الصهيوني بالمثل، وهو أمر مثير للريبة في ظل التهديدات التي يصرح بها المسؤولون الإسرائيليون ضد المنطقة كلها.
والحقيقة أنه لا يمكن فهم هذه العلاقة، وحقيقة التوتر أو افتعاله بمعزل عن الموقف الداعم من قبل إسرائيل وجماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة للنظام المصري الحالي في أعقاب الانقلاب على التجربة الديمقراطية في مصر، وكيف سَعَت لتخفيف الضغوط الدولية عنه.
وهكذا تبدو أقوال النظام المصري، ومعه باقي الأنظمة العربية والإسلامية، وتصريحات مسؤوليها مجرد كلام في الهواء يملأ صفحات الصحف والمواقع محليًّا وعالميًّا، فيعكس حالة توتر شكلية، أو غضب مفتعل لتهدئة شعوب اعتادت القهر.