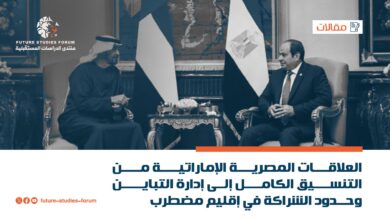منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023م، بَدَا دور مصر دورًا رئيسًا على المستوى السياسي أو الأمني أو الإنساني. فبحكم الجغرافيا والتاريخ، لم تكن مصر في يوم من الأيام دولة عادية في معادلة غزة، بل هي الجار الوحيد الذي يشارك القطاع حدوده البرية غير الخاضعة مباشرة للسيطرة الإسرائيلية. لكن هذا الموقع نفسه جعلها عرضة لضغوط مكثفة من إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف عربية مختلفة رافضة لفكرة المقاومة، سواء خلال عامي الحرب، أو فيما يخص ترتيبات اليوم التالي وباقي مراحل الاتفاق الحالي.
ماذا تريد إسرائيل؟
ومن هنا تطرح الحرب الأخيرة سؤالًا مركزيًّا: ماذا تريد إسرائيل فعًلا من مصر في قطاع غزة؟ خصوصًا بعد أن أدركت إسرائيل وحلفاؤها والمهتمون بالبُعد الإستراتيجي أن استخدام القوة بلغ ما يسميه خبراء الإستراتيجية “نقطة الذروة”، أي الحد الذي يرجح أن يسبب أضرارًا أكبر مما يجلب من منافع، وفقًا للعقيد احتياط “عيران ليرمان”، علاوة على أن عامين من الإبادة لم يحققا لإسرائيل أهدافها حول نزع سلاح المقاومة، أو إبعاد حركة حماس من إدارة القطاع.
يرى ليرمان في مقاله المنشور في معهد القدس للإستراتيجية والأمن، في 29 أكتوبر 2025م، أن الخيار الدبلوماسي للحل في قطاع غزة، إن استطاع الصمود، قد يؤثر على المنطقة كلها، فإما أن تتمكن دول مثل تركيا وقطر من التدخل في صناعة القرار، أو أن تتمكن إسرائيل من استخدام أوراقها لتأمين مصالحها ومصالح معسكر الاستقرار في المنطقة. ولكي يتحقق الاحتمال الأخير ينبغي أن تضع إسرائيل تصورًا يتوافق مع الخط العام لخطة ترامب، وتمنع هؤلاء اللاعبين المعادين من إرسال قوات من أجل حفظ الاستقرار في غزة، وأن يتم إقرار بروتوكول يتيح للجيش الإسرائيلي، بمساعدة الاستخبارات الإسرائيلية، التعامل مع أي تهديدات محتملة، وأن تكون إسرائيل هي المسيطرة على عملية إعادة الإعمار، عبر جعل إدخال المواد المطلوبة إلى غزة مشروطًا بنزع سلاح حماس. إضافة إلى استخدام لغة فضفاضة فيما يخص حل الدولتين لكي يسمح ذلك للدول العربية والإسلامية المهتمة بالتحرك نحو التطبيع.
ما ذكره ليرمان يعني ضمنًا أن ثمَّة رغبة إسرائيلية باستبعاد أطراف بعينها من المشاركة في أي قوات مشتركة تدخل قطاع غزة من أجل تثبيت وقف الحرب، والحديث هنا عن تركيا تحديدًا. ويتوافق هذا الأمر مع ما صرح به نتنياهو في أكثر من مناسبة عن أن “إسرائيل هي مَن ستحدد الدول التي ستشارك في هذه القوة، ومَن لن تشارك”، وهو ما تصاعد أكثر بعد قائمة المطلوبين الإسرائيليّين التي أصدرتها تركيا والتي ضمت 37 اسمًا لمسؤولين سياسيّين وعسكريّين إسرائيليّين بينهم نتنياهو وكاتس وبن جفير وغيرهم. وهذا الكلام يعني أيضًا أن إسرائيل تأمل في أن تتخذ دول عربية نفس الموقف فيما يخص مشاركة تركيا في القوة المشتركة، في حال تمَّ الاتفاق على هذا المبدأ في مراحل الاتفاق التالية، وربما تعول إسرائيل على أن يكون الموقف المصري في نفس الاتجاه، حتى لو لأسباب تخص مصر. ومن المحتمل أن غياب وزير الخارجية المصري عن اجتماع غزة الوزاري الذي عقد في إسطنبول الاثنين 3 نوفمبر، كان للتعبير عن الرفض المصري للمشاركة التركية المحتملة في هذه القوات. ويرتكز التصور الإسرائيلي على أن تهتم هذه القوات أساسًا بتنفيذ ما تريده إسرائيل، من نزع لسلاح المقاومة، والعمل على عدم استعادة الفصائل قوتها، بل وأن تقف صامتة أمام أي عمليات عسكرية إسرائيلية ترى إسرائيل أنها ضرورية ضد الفلسطينيّين في غزة.
الدور المصري المطلوب:
والحقيقة أن ما تريده إسرائيل من مصر يمكن تلخيصه في ثلاثة محاور أساسية: الأمن والسيطرة، الترتيبات السياسية بعد الحرب، والموازنة الإقليمية. فمنذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في القطاع، تركزت مساعي إسرائيل على فرض طوق كامل حول غزة، بحيث تصبح كل المنافذ، بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر، خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لإشرافها. وكانت إسرائيل أعلنت، في مايو 2024م، سيطرتها على “محور صلاح الدين/فيلادلفي”، الممتد على طول الحدود بين غزة ومصر بنحو 14 كيلومترًا، بدعوى منع تهريب السلاح إلى غزة. وهي خطوة كانت خرقًا إسرائيليًّا للاتفاقيات الأمنية مع مصر القائمة منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979م، وللاتفاق العسكري الملحق بها الذي ينظم انتشار القوات في سيناء والمناطق المتاخمة في فلسطين المحتلة. وبذلك أصبحت إسرائيل على تماس مباشر مع الأراضي المصرية بعد عقود من الفصل الأمني الذي ضمنتْه اتفاقية كامب ديفيد (التي كانت تسمح فقط بقوات عسكرية محدودة، وتمنع نشر أي قوات ثقيلة على مسافة 2.5 كم على طول الحدود). وعلى الرغم أن إسرائيل، سوقت هذه العملية حينها بوصفها إجراءً دفاعيًّا لمنع تهريب السلاح للمقاومة، فإنها في الحقيقة تحمل بعدًا سياسيًّا أكبر من ذلك؛ إذ تمنح إسرائيل نفوذًا إضافيًّا في تحديد شكل العلاقة بين مصر وغزة، وربما يقيد هامش الحركة المصري في إدارة المعبر والوساطة مع الفصائل الفلسطينية.
في موازاة ذلك، تصاعدت نقاشات إسرائيلية داخلية حول ما يُعرَف بـ”الخيار المصري”، أي فكرة توسيع الدور المصري فيما بعد الحرب في غزة، سواء في مسألة نشر قوات تشارك فيها مصر، أو عبر تولي مسؤولية مؤقتة عن المعابر أو المشاركة في إعادة الإعمار. وربما تضمنت هذه النقاشات أيضًا سعيًا أن تقبل مصر استقبال موجة من النازحين الفلسطينيّين في سيناء، بعد أن تفرض إسرائيل التهجير على سكان القطاع، قبل أن تُفشل المقاومة ومن ورائها الفلسطينيون هذا المخطط، في نفس وقت إصرار القاهرة على رفضه.
في الوقت ذاته، لا يمكن إغفال ما تدركه إسرائيل من أن القاهرة، رغم رفضها التهجير، تبقى الشريك الوحيد القادر على ضبط حدود غزة من الجهة الجنوبية، وعلى التوسط مع حركة حماس بفاعلية نسبية. لذلك، فإن أحد أهم ما تريده إسرائيل من مصر هو ضمان تعاون أمني متواصل في مراقبة الحدود، سواء عبر التنسيق الميداني أو تبادل المعلومات. فمنذ عام 2005م، وبعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة، تولت مصر مسؤولية ضبط الحدود في إطار اتفاق “فيلادلفي” الأمني مع إسرائيل، والذي كان يسمح لمصر بنشر قوة من 750 فرد حرس حدودي لتسيير دوريات على الجانب المصري الملاصق للقطاع لمنع التهريب والتسلل وأي أنشطة معادية. لكن إسرائيل كانت تشكو مرارًا من عدم سيطرة القاهرة بالكامل على الأنفاق المنتشرة في رفح، والتي استخدمتها الفصائل الفلسطينية لإدخال السلاح أو البضائع. بعد الحرب الأخيرة، تسعى إسرائيل إلى فرض آلية جديدة تضمن رقابة أكثر صرامة، وربما إشرافًا تقنيًّا إسرائيليًّا غير مباشر، عبر الطائرات المُسيَّرة أو أجهزة المراقبة الذكية.
المطلب الإسرائيلي الثاني يتمثل في توسيع الدور المصري السياسي ليكون غطاءً للتسويات التي تريد إسرائيل فرضها في مرحلة “اليوم التالي” للحرب. فالقاهرة وقطر هما الوسيطان الأساسيان بين إسرائيل وحماس منذ سنوات، مع تفضيل إسرائيلي دائم لوساطة مصر، على اعتبار ما ينطق به مسؤولون إسرائيليون وما تكتب عنه مراكز الأبحاث الإستراتيجية. وترغب إسرائيل أن تستمر مصر في لعب هذا الدور التفاوضي باستمرار، على أن تقوم القاهرة بممارسة ضغط فعلي على حماس لقبول الشروط الإسرائيلية، لا أن تكون مجرد ناقل للرسائل بين الطرفين. غير أن الدور المصري لا يخلو من التعقيد. فبينما تعتمد إسرائيل على مصر لتأمين التهدئة أو الرغبة في الضغط على الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حماس، فإن القاهرة تستخدم الورقة الفلسطينية للحفاظ على مكانتها الإقليمية. فمصر، التي فقدت كثيرًا من نفوذها في ملفات عربية أخرى خلال العقد الماضي، ترى في القضية الفلسطينية مجالًا لفرض حضورها الدبلوماسي، خصوصًا في مواجهة أدوار منافسة تمارسها قطر وتركيا. لذلك، فهي لا ترغب أن تتحول إلى أداة تنفيذ لإستراتيجية إسرائيلية بحتة في غزة، بل تسعى إلى الحفاظ على توازن دقيق: دعم التهدئة دون الظهور وكأنها تتبنى الموقف الإسرائيلي.
ويَرتبط البُعد الثالث بما تريده إسرائيل من مصر في الملف الإنساني والمعيشي في غزة. فلطالما كان معبر رفح المعبر الوحيد في غزة الذي لم يكن تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة. وخلال الحرب، وبعد أن سيطرت إسرائيل على محور صلاح الدين ومعبر رفح، سعت إلى ربط فتح المعبر بشروط أمنية، ومن ثم كانت المعونات رهينة المساومات السياسية التي تمثلت في مطالبة إسرائيل بأن تخضع القوافل الإنسانية لتفتيش مشترك، وأن تحصل الشاحنات على “تصريح أمني” من الجانب الإسرائيلي، حتى لو دخلت عبر الحدود المصرية. وهو توجه كان يعني أن تمد إسرائيل سيطرتها غير المباشرة إلى خارج حدودها الفعلية. وكان رفض مصر لذلك يعني أن تصبح جزءًا من منظومة الحصار اللوجستي على القطاع، وهو ما حدث فعليًّا على أرض الواقع.
أما في سياق ما بعد الحرب، فإنه بينما ترغب مصر أن يكون لها إسهام كبير في الإشراف على إعادة إعمار القطاع، لما يتوقع أن يكون ذا فائدة اقتصادية بالنسبة لها، فإن إسرائيل تريد أن تكون القاهرة “ضامنًا” لعدم استفادة حماس من أموال الإعمار أو عودة نشاطها العسكري. وبعبارة أخرى، تريد إسرائيل أن تتحول مصر إلى جهة رقابة اقتصادية على غزة، بحيث تُبقِي الوضع تحت السيطرة دون أن تضطر تل أبيب لتحمل عبء الإدارة المباشرة أو الاحتلال الدائم.
إعادة رسم دور مصر الإقليمي:
من الواضح إذا أن ما تريده إسرائيل من مصر ليس مطلبًا واحدًا، بل منظومة من المطالب تتراوح بين الأمني والسياسي والاقتصادي. لكن هذه المنظومة تصطدم بجملة من العقبات. أولها أن أي وجود إسرائيلي دائم على الحدود مع مصر، بما يخالف اتفاقية السلام والملاحق الأمنية، وأي اتفاقات أخرى لاحقة، يمثل تهديدًا لمعادلة أمنية راسخة منذ أكثر من أربعة عقود. وثانيها أن الرأي العام الداخلي في مصر يرفض أي دور يمكن تفسيره على أنه “تطبيع ميداني” مع الحرب الإسرائيلية على غزة، أو انحياز للجانب الإسرائيلي. وثالثها أن استئناف الحرب وما يرتبط بها من سيناريو تهجير محتمل، أو قبول مصر بأي ترتيبات تتضمن تهجيرًا أو إشرافًا إسرائيليًّا على الحدود قد يفتح عليها أبواب أزمة داخلية وأممية يصعب احتواؤها. ومن ثم فإنها، وحسب موقع القناة 14 الإسرائيلية، تبذل طاقتها للمضي قدمًا في مراحل الاتفاق التالية ومنع التهجير.
وإذا كانت مصر ترغب في الحفاظ على قنوات الاتصال والتنسيق الأمني مع إسرائيل تجنبًا لأي تصعيد مباشر، وتحقيقًا لأي مصالح مشتركة، فهي غالبًا تدرك أن إسرائيل تريد إعادة تعريف العلاقة مع مصر، وتريد أيضًا استخدام هذه القنوات لتوسيع نفوذها في الحدود الجنوبية. وفي هذا السياق تراهن إسرائيل على أن مصالحها المشتركة مع مصر، سواء الأمن في سيناء واستقرار الحدود بين البلدين، أو اعتماد مصر على إسرائيل في ملف الغاز والطاقة، فضلًا عن شراكتها معها في مشاريع تصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، سوف تدفع مصر في النهاية إلى قبول شكل من أشكال التفاهم الجديد حول غزة، أو التغاضي عن بعض التحركات العسكرية الإسرائيلية على الحدود.
وهكذا تعكس العلاقة بين القاهرة وتل أبيب التوازنات المعقدة التي تحكم الشرق الأوسط اليوم. وتُظهِر أن ما تريده إسرائيل من مصر في غزة اليوم يتجاوز الجغرافيا إلى محاولة إعادة رسم دور مصر الإقليمي، لكن السؤال الذي لم يُجب بعد هو ما إذا كانت القاهرة سوف تقبل بهذا الدور أم ستستخدم الملف الفلسطيني لاستعادة مكانتها قوة إقليمية مستقلة، لا وكيلًا في معادلة أمنية تفرضها الولايات المتحدة، وتكون على المقاس الإسرائيلي.